مغربنا1-Maghribona1:القاسمي/ع هرب من قصره الرائع في مراكش وقضى أشهر في الريف لتجنب العدوى. وفي القرن السادس عشر، توفي السلطان السعدي أحمد المنصور في نهاية المطاف بسبب الطاعون، على الرغم من التدابير الوقائية.
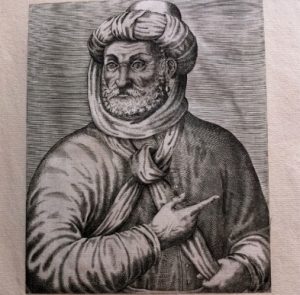
في نهاية القرن السادس عشر، شهد السلطان أحمد المنصور ضربة لإمبراطوريته بالطاعون القاتل. طالت الموجة الأولى من الوباء المغرب بين عامي 1597 و1598، مما أدى إلى تعطيل هيمنة السلطان السعدي القوي في تلك الفترة.
تسجل الروايات التاريخية كيف كان المغرب يمر بـ "سلسلة من المجاعات المدمرة والطاعون التي عطلت السنوات الأخيرة من حكم المنصور".
في الواقع، تشير الأرقام إلى ما لا يقل عن 450 ألف حالة وفاة في المغرب، في عام 1598، بسبب الطاعون، توقفت التجارة وأغلقت أهم الموانئ في البلاد بسبب الأزمة الصحية.
وبحسب أستاذ التاريخ الإسلامي "ستيفن كوري"، فإن مدينة فاس كانت من بين "أكثر الأماكن تضررا في ذلك الوقت".
ويضيف المؤرخ في كتابه “إحياء الخلافة الإسلامية في أوائل المغرب الحديث” (طبعات روتليدج، 2016)، أن الطاعون وصل في نهاية المطاف إلى مراكش، عاصمة أحمد المنصور آنذاك.
 ويذكر تقرير إنجليزي يعود تاريخه إلى يونيو 1598 أن 230 ألف شخص ماتوا في العاصمة السعدية "مراكش" بسبب الطاعون.
وكان الوضع مميتًا بالنسبة للسلطان الذي اضطر إلى مغادرة مراكش لتجنب الإصابة بالعدوى.
ويذكر تقرير إنجليزي يعود تاريخه إلى يونيو 1598 أن 230 ألف شخص ماتوا في العاصمة السعدية "مراكش" بسبب الطاعون.
وكان الوضع مميتًا بالنسبة للسلطان الذي اضطر إلى مغادرة مراكش لتجنب الإصابة بالعدوى.
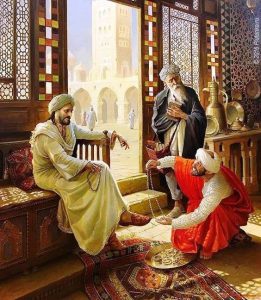
وبحسب التقرير نفسه، فإن المنصور "تخلى عن قصره الرائع وحكم من الخيام في الريف خلال أشهر الصيف عندما كان الطاعون في ذروته"
وبينما كان المنصور يعيش في الخيام، بعيداً عن الطاعون، كانت البلاد تعيش في حالة من عدم اليقين التام.
ونقلاً عن مراقبين إنجليز، كتب "كوري ستيفن" أن "التجار الذين يسافرون إلى المغرب وجدوا الموانئ مهجورة" وأن السلطات "كان يتعذر عليه الوصول إليها في كثير من الأحيان بسبب الوفاة أو المرض".

وقد فتح انعدام الأمن الطريق أمام العنف والشائعات. وكتب المؤرخ: “كانت الأوضاع سيئة للغاية لدرجة أنه قيل إن المنصور نفسه قد مات”.
"مثل هذا الضعف الكبير للحكومة المركزية أثار مسألة مدى تعرض المغرب لهجوم خارجي، ونتيجة لذلك، انتشرت شائعات مفادها أن إسبانيا أو العثمانيين كانوا يخططون لغزو البلاد خلال فترة ضعفها".

بين عامي 1599 و1601، تضاءل الطاعون ووفياته لكنه استؤنف في العام التالي.
وفي عام 1602، أرسل المنصور، الذي غادر مراكش، مراسلات إلى ابنه أبو فارس، والي المدينة الحمراء.
يكتب كوري: “في رسالته المؤرخة في الأول من سبتمبر 1602، أعطى المنصور تعليمات لأبي فارس بشأن ما يجب عليه فعله إذا وصل الطاعون (مرة أخرى) إلى أبواب مراكش”.
وكما كان متوقعا، اجتاح الطاعون المدينة، مما اضطر أبو فارس إلى القيام بما فعله والده "لتقليل خطر الإصابة بالطاعون".
في هذه الأثناء، كان والد أبو فارس يخوض معركة مختلفة ضد ابنه الأكبر الآخر. بعد أن اضطر المنصور إلى ترك خيامه في الريف، توجه إلى فاس مع جيشه لمحاربة محمد الشيخ المأمون الذي "تمرد عليه بنية الاستيلاء على عرشه"، كما كتبت "مرسيدس غارسيا أرينال" في "أحمد المأمون". منصور: بدايات المغرب الحديث” (إصدارات منشورات Oneworld، 2012).

وبعد أن أرسل المنصور علمائه إلى ابنه "لإقناعه بالتخلي عن طريق التمرد وعرض حكومة سجلماسة"، قرر قتاله بعد رفضه.
في أكتوبر 1602، واجه المنصور وابنه بعضهما البعض، قبل أن ينتصر الأب في هذه المعركة.
ولكن على الرغم من أن السلطان خرج منتصرا، إلا أن الحرب ضد الطاعون لم تنته بعد وبالفعل، لم يعد المنصور إلى قصره بمراكش بعد سفره إلى فاس.

وفي ضواحي المدينة، التي كانت الأكثر تضرراً من الوباء، انتهى الأمر بآل المنصور إلى الإصابة بالفيروس.
كتبت "مرسيدس غارسيا أرينال" : "لقد توفي بسبب الطاعون بينما كان في ضواحي فاس مع جيشه في غشت 1603". تم تقديم "حفل بسيط للغاية" للحاكم العظيم الذي غزا إمبراطورية سونغاي وهزم ملكًا أوروبيًا عند وفاته. ودفن في فاس ثم نقل بعد سنوات إلى مراكش حيث يدفن حاليا مع أجداده في مقابر السعديين.

وبما أن حالة عدم اليقين والمجاعة والمرض كانت علامة على نهاية عهده، فقد ميز الارتباك والانقسام الفترة التي أعقبت وفاته حيث شكل ابناه القويان كياناتهما وجيوشهما وتحالفاتهما.
حكم محمد الشيخ المأمون شمال المغرب من عام 1603 إلى 1608 من فاس، بينما حكم شقيقه أبو فارس عبد الله جنوب المغرب من مراكش.
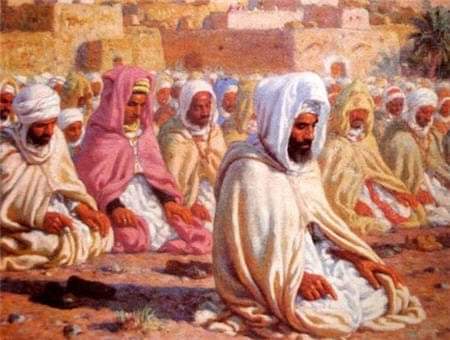




لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك